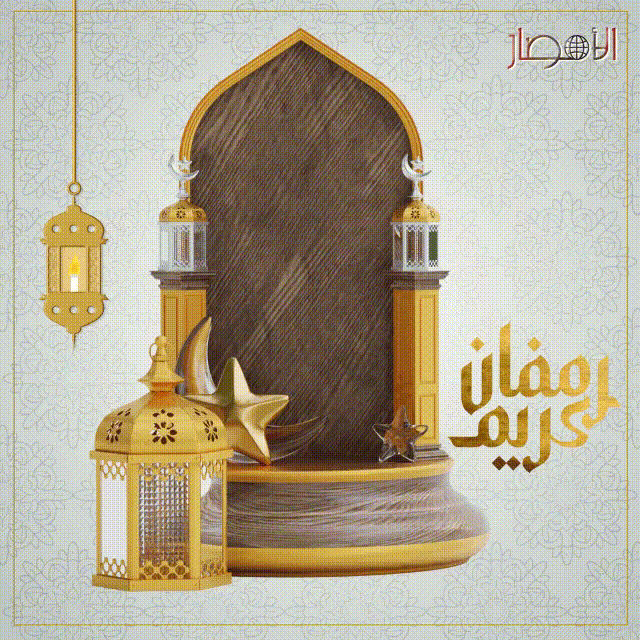هل تتراجع ركائز الاستقرار العالمي خلال 2026؟

أثار الهجوم الأمريكي على فنزويلا في الثالث من يناير 2026، والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتهريب، موجة واسعة من الجدل الدولي حول مستقبل الاستقرار العالمي وحدود احترام سيادة الدول.
العملية التي وُصفت بأنها “سابقة خطيرة” فتحت الباب أمام تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان هذا السلوك قد يتحول إلى نموذج قابل للتكرار في إدارة الصراعات الدولية، خاصة من جانب القوى الكبرى.
ويرى مراقبون أن خطورة هذه السابقة لا تكمن فقط في طبيعتها العسكرية، بل في دلالتها السياسية، إذ تعكس تراجعًا واضحًا في الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وتهميشًا لدور المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن، الذي أنشئ أساسًا لحفظ السلم والأمن الدوليين.
تراجع دور القانون الدولي وتآكل سيادة الدولة
أعادت عملية مادورو إلى الواجهة إشكالية احترام سيادة الدول، بعدما اعتبرتها دول عديدة انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي. فاعتقال رئيس دولة على أراضي بلاده ونقله قسرًا لمحاكمته في دولة أخرى يمثل تحوّلًا خطيرًا في طبيعة العلاقات الدولية، ويعزز منطق القوة على حساب منطق القانون.
ويرى محللون أن هذا التطور قد يشجع قوى دولية وإقليمية أخرى على اتباع الأسلوب نفسه مع خصومها، بما يؤدي إلى حالة من الفوضى في النظام الدولي، ويقوض الأسس التي استقر عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
سباق تسلح عالمي يعمق المخاوف
من بين أبرز مظاهر تقويض الاستقرار العالمي أيضًا، الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري الدولي خلال السنوات الأخيرة.
فقد أشار معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي ارتفع منذ 2023 بنسبة تقارب 7% مقارنة بعام 2022، ليصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار، قبل أن يقفز إلى قرابة 2.7 تريليون دولار في عام 2024.
وفي أوروبا، بلغ الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيًا جديدًا قدره 381 مليار يورو في عام 2025، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول حلف الناتو لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر بدوره من أن الإفراط في الإنفاق العسكري لا يعزز السلام، بل يغذي سباقات التسلح ويعمق انعدام الثقة بين الدول، ويستنزف الموارد التي كان من الممكن توجيهها إلى التنمية والاستقرار.
تنامي النزعات الانفصالية في مناطق مختلفة
من الملامح الأخرى المقلقة على صعيد الاستقرار العالمي، تصاعد النزعات الانفصالية في عدد من الدول.
ففي الشرق الأوسط، تتجلى هذه الظاهرة بوضوح في دول تعاني أزمات ممتدة مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق، حيث تتداخل المطالب الانفصالية مع صراعات داخلية وتدخلات إقليمية ودولية.
لكن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الدول النامية، بل امتدت إلى دول متقدمة أيضًا.
ففي الولايات المتحدة، ظهرت أصوات متزايدة في ولاية كاليفورنيا تطالب بالانفصال عن الاتحاد الفيدرالي، استنادًا إلى قوتها الاقتصادية.
كما عاد ملف انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا إلى الواجهة بين الحين والآخر، بما يعكس هشاشة بعض البنى الوطنية حتى في الدول الديمقراطية المستقرة.
خطاب سياسي يتجاهل سيادة الدول
ساهمت مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في تعميق المخاوف بشأن تراجع احترام سيادة الدول. فقد أثارت تصريحاته حول كندا واعتبارها “الولاية رقم 51”، ومطالبته باستعادة قناة بنما، ورغبته المتجددة في ضم جزيرة جرينلاند الدنماركية، انتقادات واسعة باعتبارها تعبيرًا عن نزعة توسعية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وتكتسب قضية جرينلاند أهمية خاصة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقيمتها الجيوسياسية. وقد أدى الحديث الأمريكي المتكرر عن إمكانية الاستحواذ على الجزيرة إلى توترات داخل حلف الناتو نفسه، خاصة أن الدنمارك عضو في الحلف، ما يضع أوروبا أمام معضلة حقيقية تتعلق بأمنها واستقلال قرارها.
عودة منطق مناطق النفوذ
يرى خبراء في العلاقات الدولية أن العالم يتجه تدريجيًا نحو إعادة إنتاج نموذج اقتسام مناطق النفوذ بين القوى الكبرى، على غرار ما حدث في مؤتمر يالطا عام 1945. فالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، رغم ما يعتريها من تنافس، توحي بوجود تفاهمات غير معلنة حول حدود النفوذ والمصالح.
ويستشهد هؤلاء بما يصفونه بالخطاب الودي المتبادل بين ترامب وبوتين، وبمواقف الطرفين من أزمات كبرى مثل أوكرانيا وغزة والمواجهة الإسرائيلية الإيرانية، حيث يلاحظ الاكتفاء بالتصريحات دون تدخلات حاسمة.
كما أن التوتر التجاري بين واشنطن وبكين يبدو في طريقه إلى التهدئة، بما يعكس حرص القوى الكبرى على إدارة الخلافات بما يحفظ مصالحها الأساسية.
هذا الواقع يضع الدول الصغيرة والمتوسطة أمام تحديات كبيرة، في ظل نظام دولي يميل إلى الأحادية ويعيد الاعتبار لمنطق القوة، وهو ما قد يقود العالم إلى مرحلة من الاستقرار الهش أو الفوضى المحتملة.
هل لا يزال الأمل قائمًا؟
على الرغم من هذه الصورة القاتمة، يرى بعض المراقبين أن الأمل في استعادة قدر من الاستقرار العالمي لا يزال ممكنًا.
فالعالم يواجه تحديات مشتركة لا يمكن التعامل معها إلا عبر التعاون الدولي، مثل التغير المناخي، وانتشار الأوبئة، وأزمات الهجرة واللجوء، إلى جانب المخاطر المتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما أن عام 2026 يشهد انتخابات في نحو 21 دولة حول العالم، ما يمنح الشعوب فرصة لاختيار قيادات أكثر قدرة على تغليب منطق التعاون على منطق الصراع.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يتجه العالم نحو ترسيخ نظام دولي أكثر اضطرابًا، أم أن الضغوط المتراكمة ستدفع نحو إعادة إحياء فكرة الشراكة الدولية كأساس للاستقرار؟