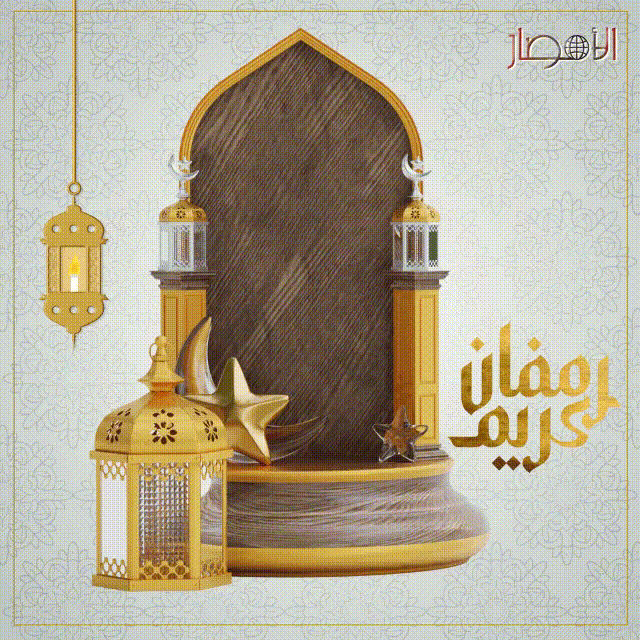د. حسن أبو طالب يكتب: «قوة الاستقرار» والمخاطر الكامنة

من المعروف تاريخياً أنَّ العديد من القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عادة ما تتضمَّن عبارات وجملاً غامضة، رغم شمولها ألفاظاً تبدو براقة، ومن ثَم يمكن الالتفاف عليها، وتفسيرها في اتجاهات متضاربة ومتناقضة. الحالة الأبرز تتضح في القرار الدولي رقم 242 الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1967، بخصوص تداعيات العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن، والذي صاغته الدبلوماسية البريطانية آنذاك، وشمل عبارة الانسحاب الإسرائيلي من «أراضٍ محتلة»، وليست «الأراضي المحتلة»، والتي قُصد بها سيناء المصرية، والجولان السورية، والضفة الغربية. ومع غياب «ال» التعريف، فسَّرت إسرائيل -بدعم غربي- أنَّ الأمر لا يتعلق بكل الأراضي المحتلة، وإنما ما تقبل الانسحاب منه فقط. وهو تفسير ما زالت تداعياته الكارثية قائمة في الضفة الغربية والجولان السورية المحتلة.
شيء من هذا القبيل يُراد تمريره فيما تُعرف بـ«قوة حفظ الاستقرار في غزة»، وهي القوة المقترحة في خطة الرئيس ترمب كمبدأ، وتسعى واشنطن لتقديم تعريف لتلك القوة يُراعي المطالب الإسرائيلية حصراً، على أن يصدر قرار من مجلس الأمن يرحب بمجلس السلام برئاسة الرئيس ترمب، وبقوة الاستقرار التنفيذية، دون أن يكون لمجلس الأمن صلاحية الإشراف على تلك القوة ومتابعتها وفق تطبيقات قوات حفظ السلام الدولية المعتادة. ووفقاً لهذه المعادلة التي تجمع -موضوعاً- بين الأهداف الكلية لتل أبيب، والرضاء العربي والإسلامي شكلاً، لا تبدو فرص النجاح قائمة كما تتصورها واشنطن وتتمناها حكومة تل أبيب.
لقد تعلم العرب الدرس مراراً طوال العقود السبعة الماضية، والوقوع في مثل هذا الفخ السياسي والاستراتيجي مرة أخرى، يعني أن القضية الفلسطينية لن تبرح مكانها نحو استقرار أو سلام، وهما التعبيران الأكثر تكراراً في المواقف الأميركية المعلنة؛ بل ستأخذ منحى أكثر خطورة، فوجود قوة دولية بعيدة عن ضوابط ومعايير ميثاق الأمم المتحدة، يعني تسليم القطاع إلى من يُشرف على تلك القوة، وهو مجلس السلام المقترح، والذي سيعمل وفق إرادة البيت الأبيض، بعيداً عن ميثاق الأمم المتحدة، وكأن المطلوب هو انتزاع موافقة عربية وإسلامية لعودة الانتداب وفق صيغة معدلة، لجزء من الأرض الفلسطينية.
وتتجلى المخاطر المتوقعة في أبعاد عدة، نشير إلى بعضها:
أولها أن القوة الدولية المنتظرة ستكلَّف بمهام تنفيذية، وهي ببساطة الدخول في مواجهة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع من أجل نزع سلاحها، وتلك بدورها وصفة للفوضى وليس للاستقرار.
وثانيها ما يتسرب حول مفاوضات أميركية إسرائيلية، تحصل بموجبها إسرائيل على «حقوق» عدة: أولًا حق النقض لمن يشارك أو لا يشارك في تلك القوة، ما يحقق ارتياح إسرائيل. وثانياً حق العمل العسكري في القطاع بزعم مواجهة التهديدات التي تحدد ماهيتها إسرائيل منفردة، من دون أن يكون ذلك نقضاً لمبدأ وقف إطلاق النار، وهو الأساس الذي تقوم عليه خطة الرئيس ترمب، ما يعني أن البيت الأبيض يتفاوض على أن يعطي ميزات حصرية لإسرائيل، تعيد إنتاج النموذج السائد في لبنان؛ حيث يستمر قصف واحتلال مناطق مختلفة في جنوب البلاد، بزعم منع تهديدات «حزب الله»، وهو ما تقبله واشنطن عن طيب خاطر؛ بل وتدافع عنه، الأمر الذي يتناقض مع جوهر خطة الرئيس ترمب ذاتها الخاصة بغزة. وثالثاً حق إسرائيل في التراجع عن الانسحاب من المناطق المحتلة في القطاع، وتقدر بـ53 في المائة من مساحته، بحجة تدمير الأنفاق المحتمل أن تكون موجودة في تلك المناطق، وضمان أمن إسرائيل.
ومما يثير العجب والدهشة معاً، ذلك التصور الذي يروِّج له محللون وسياسيون أميركيون بشأن تقسيم قطاع غزة، إلى شرق تحتله إسرائيل ويتم إعماره، وغرب يقع تحت نفوذ «حماس» ويتم إهماله، وأن يتوفر التمويل العربي والدولي للجزء الشرقي المُحتل، وأن يُترك غرب القطاع ضائعاً، ما يعتبرونه نوعاً من إعطاء الأمل للفلسطينيين يقوم على أن الخضوع للاحتلال سيوفر لهم الحياة الرغيدة، وأن من يقاوم الاحتلال سيُترك للبؤس والضياع. ويتناسى أصحاب هذا التفكير البائس والعبثي، والذي يعد امتداداً لنخبة اليمين الإسرائيلي الحاكمة، أن لا أحد من العرب والمسلمين ولا من مؤسسات التمويل الدولية، سيرحب بتعمير المناطق المحتلة، لما في ذلك من تكريس للاحتلال ذاته، والاعتراف بتقسيم القطاع، والتفرقة بين أصحابه الأصليين. فالاحتلال سيظل احتلالاً متصادماً مع الكرامة الوطنية وحقوق الإنسان في الحرية، مهما أُعطِي رتوشاً من التجميل، وأوهاماً برغد العيش لن تتحقق.
المفارقة هنا أن الدبلوماسية الأميركية لا تعارض مثل هذه الحقوق الحصرية لإسرائيل، دون أن تضع في اعتبارها أن تقديم ضمانات أو تفاهمات حول تلك المطالب الإسرائيلية سيقود حتماً إلى تراجع فرص نجاح خطة الرئيس ترمب ذاتها، فحين يغيب التوازن بين أطراف الصراع، ولا تؤخذ في الاعتبار رؤى الشركاء والضامنين للخطة، وتستمر السياسة الأميركية في فخ الانحياز المطلق لتل أبيب، يصبح التفاؤل بقدر من الهدوء تتبعه بدايات استقرار قادر على الصمود، أمراً مشكوكاً فيه.
نعلم جميعاً أن الانحياز الأميركي لإسرائيل غير قابل للغياب ولا للتراجع؛ سواء أكان سيد البيت الأبيض جمهورياً أم ديمقراطياً؛ بيد أن الانحياز المطلق للتطرف وغياب الرشادة والعقلانية السياسية والنزوع للحصول على كل شيء كما هي الحال السائدة الآن في المجتمع الإسرائيلي ونخبته المتطرفة الحاكمة، هو أمر يثير التعجب، ولا سيما أن مؤشرات تغير اتجاهات الأجيال الصاعدة في الداخل الأميركي ذاته والرافضة السياسات العدوانية الإسرائيلية، لا بد من أن تثير لدى المؤسسات الأميركية التحفز لتغيير السياسات التي ثبت عقمها وفشلها، حتى في حماية إسرائيل ذاتها، وتتطلب تكاليف هائلة يتحملها المواطن الأميركي، وموازنة بلده غير القادرة على تكاليف عمل حكومته الفيدرالية، وتتسبب في غضب الأصدقاء والحلفاء العرب والمسلمين.
نقلًا عن صحيفة الشرق الأوسط