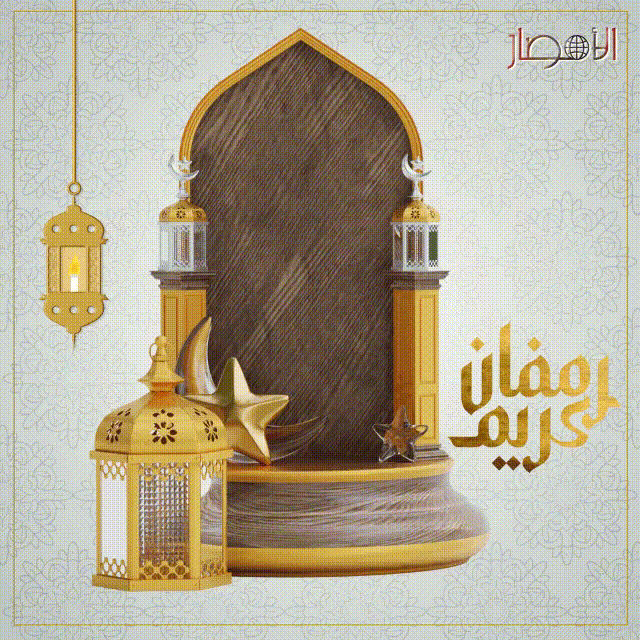حسن المصطفى يكتب: «السلاح أكثر من مجرد معضلة أمنية وسياسية»

تطرح مسألة حصر السلاح بيد الدولة إشكالية مركزية في العالم العربي، لا لأنَّها قضية أمنية وسياسية فقط، بل لأنَّها تتعلق بجوهر معنى الدولة الحديثة، التي يعد احتكار «العنف المشروع» داخل مؤسساتها، إحدى أبرز سماتها. ولذا، فإنَّ المعضلة الكبرى هي مفاهيمية، تعود إلى تصور غير ناجز لكُنهِ الدولة، وبالتالي يكون للفاعلين خارجها أو ما دونها هيمنة أكبر، مما يتطلب الاشتغال بعمق على بناء وعي ثقافي واجتماعي وقانوني، يحل مكان التصورات القديمة التي رسَّختها عبر سنوات التياراتُ المناهضة للدولة الحديثة!
العراق ولبنان يشكّلان نموذجين بارزين لهذه المعضلة، بينما تُضاف إليهما اليمن وسوريا وبعض الدول العربية الأخرى كليبيا، حيث لعبت الميليشيات أدواراً تتجاوز الدولة، وأضعفت الاستقرار السياسي وهددت السلم الأهلي، دون إغفال الآثار السلبية لبعض العوامل الخارجية، كالممارسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون، وعمليات القتل والتهجير والاحتلال التي تمارسها، والتي خلقت مناخات مواتية أضعفت بنية الدولة الوطنية، وزادت من شوكة السلاح خارجها!
في الحالة العراقية، ومنذ عام 2003، ظهرت عشرات الميليشيات، بعضها اندرج لاحقاً في إطار «الحشد الشعبي»، إلا أنّ ولاءاته بقيت متشعبة، بين الانتماء المذهبي والارتباطات الإقليمية وتحديداً لإيران، كونه بات إحدى الأذرع الفاعلة لـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري». هذه الكيانات أصبحت لاعباً موازياً للحكومة، تتحكم في الحدود والموارد وتفرض اقتصاداً موازياً، وبعضها بات له تمثيل في «مجلس النواب»، مما يعني أنه فرض ذاته على أنه أمر واقع بقوة السلاح والخطاب الديني والعمل السياسي معاً!
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبّر حديثاً عن مقاربة واضحة تجاه موضوع السلاح، حين قال: «في بيئة مستقرة كحال العراق اليوم، لا يوجد مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن «الدولة فقط هي التي تحتكر استخدام القوة، ويجب على الجميع -خصوصاً العشائر- دعم سلطة القانون والقضاء»، إلا أنَّ هذه المقاربة تبقى نظرية، خصوصاً أن جزءاً من حلفاء رئيس الوزراء الذين أيَّدوه في تولي المنصب، يمتلكون تشكيلات مسلحة أيضاً، ولذا فإنَّ مساعي السوداني رغم صدقها وجديتها، فإنَّها تصطدم بكثير من العقبات التي عليه أن يعمل على تجاوزها بشجاعة وحكمة في آن معاً.
السوداني حاول أن يُطمئن الداخل، مؤكداً أن مسار ضبط السلاح لا يستهدف جهة بعينها، بل يسعى إلى إعلاء سلطة القانون. وقد اتخذت حكومته بالفعل إجراءات ضد تجاوزات نُسبت إلى عناصر من «كتائب حزب الله»، في رسالة تفيد بأن زمن التساهل يقترب من نهايته، إلا أنه أيضاً يحتاج إلى دعم واضح من الأحزاب العراقية وحلفائه، كي يستطيع أن يبسط سلطة الدولة على السلاح الخارج عن القانون.
الخطوة لم تقبل بها الميليشيات؛ إذ دعت «كتائب حزب الله» إلى ما سمته «الحَجْر» على قرارات رئيس الوزراء العراقي، مطالبةً «الإطار التنسيقي» باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. كما أن الأمين العام لـ«الكتائب» أبو حسين الحميداوي، قال في بيان نُشر عبر «تلغرام»، إن «سلاح المقاومة خط أحمر، ولن نسلّمه حتى لو واجهنا ضغوطاً داخلية أو خارجية، لأن هذا السلاح وُجد لحماية العراق ومواجهة الاحتلال».
هذا الموقف يعكس ثنائية حادة: دولة تريد فرض سيادتها، وميليشيات ترى نفسها فوق الدولة، محمية بشرعية «المقاومة»، رغم أن ما حصل من تصدع لـ«محور المقاومة» منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يثبت أن هذا السلاح ليس بإمكانه حماية الدولة!
في لبنان، القضية أكثر تعقيداً. فـ«حزب الله» ليس مجرد فصيل مسلح، بل قوة اجتماعية وعسكرية وسياسية تتجاوز قدرات الجيش النظامي. هذا الوضع جعل الدولة اللبنانية أسيرة ازدواجية خطيرة: دولة رسمية ضعيفة، ودولة ظل تتحكم في قرار السلم والحرب.
رئيس الجمهورية جوزيف عون، أعلن بوضوح أنه «لا يُسمح بأي مجموعات مسلحة تعمل خارج الدولة أو تعتمد على دعم خارجي»، مؤكداً أن «الجيش وحده مسؤول عن الدفاع عن المواطنين». في موقف يلتقي مع تصريحات رئيس الوزراء نواف سلام، الذي بيَّن أن «الجيش أُوكل إليه إعداد خطة لتوحيد السلاح في يد الدولة بحلول نهاية العام»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لا أحد في لبنان يريد العودة إلى حرب أهلية».
هذا التوجه يعكس محاولة جدية لوضع جدول زمني للتعامل مع سلاح «حزب الله» ضمن إطار مؤسساتي يهدف إلى تجنيب البلاد الانفجار. إلا أنَّ هذا الأمر أيضاً دونه عقبات كبيرة، حيث إن رد «الحزب» جاء حاداً عبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الذي رأى أنَّه «إذا استمرت الحكومة في تطبيق الخطة، فلن تكون هناك حياة في لبنان... القرار يخدم إسرائيل، ونحن مستعدون للقتال مهما كلّف الثمن».
هذا التباين المشارُ إليه أعلاه في التفكير بين منطق الدولة و«قوى ما دون الدولة»، له أسبابه الموضوعية العديدة التي تختلف من بلد عربي لآخر؛ ومنها ضعف «الدولة» إبان الحروب الأهلية، وسنوات الاحتلال أو الإرهاب والفوضى، حيث عجزت المؤسسات عن حماية المواطنين، ممَّا أضعف الثقة الشعبية، ودفع مكونات اجتماعية إلى البحث عن حماية بديلة. وهذا بدوره فتح المجال أمام التدخلات الخارجية، حيث ارتبط بعض الميليشيات بمحاور إقليمية جعلت السلاح وسيلةً لصراع الآخرين على الأرض المحلية، مما خلق بيئة هشة اجتماعياً واقتصادياً، تفاقمت فيها الأزمات المالية والفقر والبطالة، مما دفع بشرائح من الشباب إلى الانخراط في صفوف الميليشيات، بحثاً عن الراتب أو الحماية.
من هنا، معالجة أزمة السلاح خارج سلطة الدولة، تحتاج إلى عمل جادٍ ودولة قوية، وقرارات حاسمة قابلة للتطبيق، تُعيد هيبة المؤسسات، وتمكِّن الجيش الوطني من بسط نفوذ «الدولة»، وترفض بوضوح وجود السلاح لدى أي فصيلٍ كان. وبالتوازي مع ذلك، من المُلحِّ أيضاً، العمل على تقوية وتطوير المؤسسات الأمنية، وإشراك القوى الوطنية المختلفة في تحمل مسؤولياتها ضمن عملية إصلاح شاملة، ووضع خطط تنموية تعالج مشكلات البطالة وتدني مستويات الدخل.
وحده هذا المسار قادرٌ على إنهاء زمن الميليشيات التي أنهكت المنطقة، وإعادة الاعتبار إلى الدولة الوطنية بوصفها الحامي الجامع للمواطنين.
نقلًا عن صحيفة الشرق الأوسط